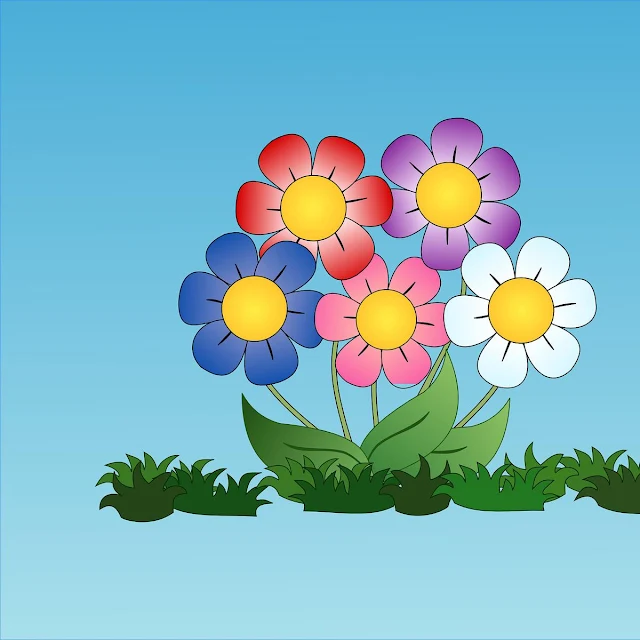أسم الكتاب: النقد والتقويم لمنتقد عقائد الماتريدية
اسم المؤلف: سعيد عبد اللطيف فودة
المذهب الفقهي: شافعي
عدد الأجزاء: 1
التصنيف: عقيدة علم الكلام
محتويات
المبحث الأول
أ- مصدر التلقي عند الماتريدية.
قال مؤلف الكتاب أن مصدر التلقي الأول في معظم ابواب التوحيد هو العقل دون النقل، وعلل ذلك بقوله : لأن الأدلة العقلية عندهم قطعية اما السمعية فإنها هي ظواهر ظنية. أهـ
كذا وضح مذهب القوم. وهذا العرض منه لمذهبهم يدل علىمعرفته الناقصة الملفقة لما يقولون، هذا إذا أحسنا فيه الظن.
ولما كثر الكلام في هذه المسألة أي مسألة العقل والنقل وموقف الأشاعرة والماتريدية - أهل الحق - منهما، وصار الكلام فيها مكررا فإننا سنوضحه هنا باختصار كاف منبهين على أصول المعاني، لا سيما أننا قد فصلنا فيها في أكثر من موضع في ما كتبناه من الردود والكتب في العقائد وأصول الفقه.
وأما هذا المؤلف فإنه اتخذ سبيل التلبيس كعادة أصحابه، فأطلق القول عليهم بأنهم يقولون أن العقل هو مصدر التلقي في معظم العقائد، وظاهر كلامه أنهم يأخذون العقائد من حيث هي دين وشرع وملة من العقل، ويوجبون ذلك بحيث يترتب العقاب والثواب على ذلك، وهذا القول باطل كما هو معلوم من نصوصهم في كتبهم المشهورة.
فالذي يقولون به إنما هو أن العقل آلة لمعرفة الوجوب الثابت لله تعالى، فهو كاشف لا مثبت، والماتريدية خصصوا الكلام في أن العقل يدرك ثبوت وجوب معرفة الله تعالى خاصة. ولهذا قال الامام البياضي في إشارات المرام صفحة 75 :
"العقل آلة لمعرفة الوجوب الثابت لله تعالى ولمعرفة الحسن اللازم لا موجب كما قالت المعتزلة.
ثم قال :
وهو معتبر وآلة لمعرفة ذلك بدون السمع. أهـ
فأين هذا الكلام من كلام هذا الكاتب الذي لايدري في أي موضوع يتكلم وفي أي بحر يغوص.
وهذا الكاتب يريد أن ينسب إلى الأحناف الماتريدية أنهم يقولون أن العقل هو الذي يملي علينا الدين لا الشرع، وهذا القول ليس ما يذهبون إليه، فانتبه لذلك، وهو يقصد بذلك أن يقدمهم إلى القارئ على أنهم يقدمون العقل على النقل، ويهملون النقل.
ثم انظر إلى سذاجته في التفكير وفي العرض وإلى تلبيسه عليهم وهو يقول : إن السبب في القول الذي يقولون به - على زعمه - هو أنهم يقولون أن العقل دلائله قطعية أما السمع فدلائله ظنية.
ولا أرى هذا إلا سخافة في تأصيل المسائل وفي بيان حقائق المذاهب. فلا علاقة أصلا للمسألة الأولى بالثانية، بل هي مسألة أخرى، وذلك أن الأخذ بما هو أخذ يتضمن التدين والإذعان والخضوع، وهذا الأمر لا يتوقف فقط على كون المأخوذ قطعيا، بل يمكن أن ينبني أيضا على مجرد كونه ظنيا، والشرط في الأخذ بهذا المعنى هو كون مصدر الأخذ هو الله تعالى أو الرسول عليه السلام، ولا يهم بعد ذلك كون المأخوذ قطعيا أو ظنيا، كغالب الأمور التعبدية. ولكن العقائد اشترط فيها كونها قطعية لما لها من محل كبير في الدين، ولكونها أصولا يقوم الدين عليها. وزيادة شرط القطع في العقائد، لا يستلزم عدم الأخذ من الله تعالى. لأن القطع يتحقق أيضا في المنقول من الشرائع، ولكن اشتراط كون المأخوذ منه هو الله أو الرسول لكي يعتبر تدينا، هو إبطال لاعتبار مجرد العقل في التدين، كما هو معلوم في أصول الدين، وهذا هو المعبر عنه عند علماء أهل السنة بأنه لا حكم إلا لله تعالى، وأنه لا حكم للعقل، يقصدون بالحكم الحكم الشرعي المأخوذ للتدين.
ثم هل يجهل هذا الكاتب أن المحققين من الأشاعرة والماتريدية قالوا بأن النصوص والنقول الشرعية بعضها يفيد القطع وبعضها يفيد الظن، وذلك حسب قوة النقل المتفاوت من المتواتر إلى الآحاد. لا أظن أن أحدا يجهل هذا الأمر، لأنه من الوضوح بمنزلة الشمس، ولكن هو الزيغ عن طريق الرشاد والحق، وهو التلبيس على عامة الناس الذي يوجه كتابه هذا اليهم.
وقد قرر أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية قبل أن يأتي مشايخ هذا الكاتب المفتون، أن النقل الصحيح الثابت المعنى لا يمكن أن يتعارض مع البراهين العقلية.
ثم إنه لم يقل أحد منهم أن الأدلة العقلية كلها قطعية، ولذلك اهتموا بترتيب مراتب الحجج وبيان القوي منها والضعيف سواء في كتب المنطق أو في كتب علم أصول الفقه وعلم التوحيد.
وأما القاعدة التي يكثر هؤلاء المجسمة في هذا العصر من الكلام عليها وي ما يُطلق عليه اسم ( القانون الكلي ) فقد تكلمت عليه في غير موضع ووضحت معناه بحيث لا يخفى على أحد([1][4]).
وهذا الكاتب الساذج قد اعترض على القانون الذي ذكره أهل السنة، ثم أعاده بمعناه في آخر كلامه، تماما كما فعل زميله الآخر سفر الحوالي في كتابه المتهافت الذي أشرنا اليه في أول الكلام.
ب- حكم تأويل النقل
أما مسألة التأويل، فهي أظهر من أن تحتاج إلى توضيح، ونحن لا نتكلم مع هذا المدعي فيها هنا بعد أن تكلم عليها فحول العلماء من المتقدمين والمتأخرين، وأجازوا التأويل بشروطه المذكورة في كتبهم.
والتحقيق في الدافع الذي يدفع هذا الكاتب وأمثاله إلى الكلام في هذه المسألة، هو كما يلي:
ان هؤلاء عبارة عن بقايا فرق المجسمة والكرامية، وإحياء لهم في هذا الزمان، وهم لا يهتمون من علم التوحيد بأكثر من نسبة الحد والجهة والمكان والأعضاء وغير ذلك إلى الله تعالى، ولما كانوا لا يملكون من العقول والنفوس الصافية المخلصة ما يؤهلهم للدفاع عن قولهم بأدلة معتبرة، لجأوا إلى القدح في كل وسيلة يستخدمها جماهير المسلمين مثل النظر العقلي وأساليب اللغة المختلفة وغير ذلك، ومن هذه الأساليب التأويل الذي هو فرع في إثبات المجاز والاستعارة والكناية وغيرها من أساليب اللغة العربية الأصيلة في البيان. قدحوا في هذا كله ليتمكنوا بعد ذلك من أن يثبتوا ما يريدون إثباته مما يتوهمون أنه ظواهر نصوص شرعية.
والسلف لم يثبتوا كيفيةً أصلا ويفوضوا العلم بها إلى الله تعالى،بل لم يتكلموا أصلا في هذه المسألة، لأنهم أمرُّوا النصوص لوضوحها كما جاءت، وهذا هو مذهب التفويض الذي قدح فيه هذا الكاتب بعد أن صوَّره تصويرا باطلا، فقال إنهم يمرون بناءا على التفويض على النصوص التي فيها الخلاف كآية الاستواء وآية اليدين وغيرهما كما يمرون على الحروف المقطعة، وشتان بين هذا القول وبين ما يعتقده أهل السنة من مذهب التفويض حيث أجمعوا كلهم على أن التفويض إنما هو تأويل إجمالي والتأويل تفصيلي.
وهؤلاء الذين ينتمون إلى السلف فى هذا العصر يُقَوِّلونهم ما لا يقولون، وينسبون اليهم الفاسد من الآراء والمعانى، لا لشىء إلا لأن أوهامهم صورت لهم أن هذا هو الحق والمذهب الصحيح وهو فى الحقيقة قول فاسد مبتدع لا دليل لهم عليه قائم بذاته إن هى إلا أقاويلهم وادعاءاتهم وتهويلاتهم.
السلف لم يقولوا أن الاستواء معناه الجلوس والاستقرار، ولم يقولوا أن الله فى مكان أو جهة وله حد من جميع الجهات وهو يتحرك بالانتقال من حيز إلى حيز؛ وأنه تقوم به الحوادث والتغيرات وأن خلقه يؤثرون به وأنه ينفعل منهم وبهم. الى غير ذلك من الترهات. وأما عقائد أهل السنة أهل الحق فهى معروفة معلومة عند كل من له عقل.
ج- علم الكلام، الموقف منه الموقف من علم الكلام، هذا الموقف الذى ينسبونه إلى السلف وهو موقف الرد التام والتبديع والتفسيق. بل التكفير فى كثير من الأوقات.
هذا الموقف هو ضحكة المتقدمين والمتأخرين، وهو السوط الذى يرهبون به كل من يقترب من علم الكلام.
والحقيقة أن فحول العلماء من أهل الإسلام، لا أقول الأشاعرة والماتريدية، بل جميع من انتمى إلى الإسلام، تمسك بهذا العلم واتبع مناهجه، وكل فرقة وطائفة لها إبداعاتها فيه، وأهل السنة - الأشاعرة والماتريدية - هم باعتراف الجميع وصلوا إلى أعلى الدرجات التحقيقية فيه.
وهذا العلم، لا يخلو إما أن يكون حقا أو باطلا. فإن كان باطلا، فلنقل أن جماهير علماء المسلمين تمسكوا بالباطل وهذا مستحيل وإلا فهو حق فى ذاته.
وأما من قدح فيه من الأولين، فإنما كان قدحه متوجها على من تكلم فيه وغلط، ولا يمكن أن يكون قادحا في من تكلم فيه وأصاب وإلا وجب ردُّ قدْحِه وجرحه كائنا من كان.
وعلم الكلام فى حقيقة الأمر، هو بحث عن الأدلة اليقينية العقلية والنقلية التى تدعم قواعد الدين.
فهو ليس عبارة عن كلمات جامدة، ولا أحكام متعنتة ولا تعصبات عمياء.
بل هو بحث واجتهاد وابتكار. بل لا نجد فى علم من العلوم الإسلامية ما يبرز الهوية الإسلامية مثلما نجد فيه.
ولا يقدح فى هذا العلم على الإطلاق إلا كل جاهل، أو غير عالم بما فيه.
ولنا كلام طويل في هذا المبحث في أكثر من موضع([2][5]).
وهل يستطيع أحد أن يدعي أن أحدا غير المتكلمين تصدى للفلاسفة.
هل سمعت عن حشوي أو مجسم تصدى للرد على نظريات الملحدين الكفار، وغيرهم ممن يقدحون في أصول الدين وفروعه، سواءا في العصور القديمة أو الحديثة.
بل نحن في هذا الزمان أشد ما نكون حاجة إلى هذا العلم وإظهاره وإبراز محاسنه وتشجيع الأذكياء من الناس على التمسك بما فيه، والخوض على قواعده ونشر الدين والدفاع عنه بناءا على ما فيه.
ومن يدعي أن المتكلمين قد قلدوا الفلاسفة من اليونان والهنود وغيرهم، فهو جاهل لا يعي ما يقول. فإن الناظر في كتب هؤلاء والعارف بما ذكره المتكلمون يعلم أنه لم يوجد نقد عقلي قوي ورد للفاسد من آراء البشر الا في كتب المتكلمين، كل هذا بالحجة والتدليل، لا بالصراخ والعويل !
المراجع
([1][4] ) أنقل هنا بعض ما قلته في ردي على كتاب "العقلانيون أفراخ المعتزلة العصريون" ومؤلفه هو (علي الحلبي) أحد الدعاة إلى ما يسمونه بمذهب السلف وهو في الحقيقة خليط من مذهب المجسمة والظاهرية ممتزجا هذا كله بمصالح دنيوية.
لما خلق الله تعالى الإنسان، وهب له وسائل للعلم، وجعله مكلفا بناءا على وجود هذه الوسائل كما ذكر بالنص البين الذي لا يمكن تأويله(والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون)، فانظر رحمك الله كيف جعل الشكر مترتبا على وجود وسائل المعرفة المذكورة، وهي السمع والأ[صار والأفئدة. وقد أمرَنا الله تعالى أن لا نتبع شيئا إلا إذا وصَلَنا عن طريق من هذه الطرق وذلك في قوله تعالى(ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا)، وفي هذا مدح لكل وسيلة من هذه الوسائل من حيث كونها طريقا إلى العلم. وقد ذم الله تعالى الكفار لأنهم يتبعون مطلق الظن والعائد إلى الشهوة النفسية، وشنع عليهم بأنهم لا يملكونعلما. وفي هذا لفت للنظر إلى وجوب استخدام هذه الوسائل، لأنها طرق العلم.
فالله تعالى هو الذي نصب هذه الوسائل طرقا للمعرفة والعلوم، وقد مدح الله أقواما لأنهم لا يعقلون، وهذا إشارة إلى مدح مطلق العقل، وأنه لا يوجد شيء اسمه عقل مذموم إلا على سبيل المجاز، إذ كيف يكون عقلا ومذموما، فهذا يناظر أن يقال:علم غلط، وهو جمع بين الضدين أو حتى بين النقيضين.
فالعقل ممدوح مطلقا، لأن الله تعالى مدحه مطلقا ومدح المتصف بالعقل، ولم يرد في نصٍّ ذمٌّ للعقل، ولا يجوز شرعا ذمه.
ولا خلاف بين العلماء أن العقل إن لم يكن هو نفسه هذه الوسائل الثلاثة أو واحدا منها، فلا بد أن يكون لا زما عنها، وما كان لازما للحق فهو حق، ويستحيل وجود لازم للحق وهو باطل.
ولما أرشدنا الله تعالى إلى وسائل المعرفة عطفها على بعض بالواو التي تفيد مطلق الجمع وما هذا إلا إشارة إلى أنه لا تعارض بين أي واحد من هذه الثلاثة، ولا يجوز وجود تعارض، ومع عدم وجود التعارض يستحيل وجود ترجيح، لأنه فرع التعارض. وعلى هذا يكون من رجح أمرا على أمر منها مخالفا لنص القرآن.
وهذا الكلام لا يجوز أن يخالف فيه إلا من لا يحصِّلُ معانيه.
فهذه مقدمة مهمة جدا في بيان الأصل الذي تقوم عليه هذه المسألة.
ومعلوم لدى كل إنسان عاقل أنه يحكم على بعض الأمور أحيانا على سبيل الجزم وأحيانا على سبيل الظن، فتبين التفرقة الضرورية بين منزلة الظن والقطع.
ومعلوم لدى كل عاقل أيضا أن للألفاظ مراتب في دلالتها وهذا الأمر اتفق عليه علماء الدين، فبعض الألفاظ لا تحتمل إلا معنى واحدا في دلالتها، وبعضها تحتمل أكثر من معنى مع رجحان في واحد أو بدونه، وهذا أيضا معلوم، فلا يشترط في اللفظ أن يدل على معنى واحد فقط.
وقد مضى بيان أن العلم يمكن أن يأتي عن طريق السمع، ويمكن أن يأتي عن طريق الفؤاد، ولا يمكن تعارض العلوم مهما كانت وسائلها.
وحيثما وقع تعارض فلا بد من وجود غلط في نسبة أحد المعنيين أو كليهما إلى وسائل المعرفة.
وحيثما وقع التعارض فيجب ترجيح العلم والقطع على غيره، بغض النظر عن مصدر أي منهما. وأما إن كان المتعارضان طنيين فينظر في القرائن والغلبة.
والمرتبة التي يدون عليها الكلام في القانون الكلي الذي ذكره العلماء، هي تعارض القطعيات مع الظنيات مطلقا، ما هو الذي يرجح عندذاك، الإجماع قائم على تقديم القطع مهما كان مصدره.
هذه هي المسألة بوضوح واختصار، وهذا هو المعنى الذي يذكره الإمام الرازي في القانون المعلوم، فهو يفرض فرضا عقليا تعارض قواطع عقلية مع ظواهر نقلية شرعية أي محتملة، فالواجب،حتما ترجيح القطعي، لا لكونه عقليا بل لكونه قطعيا، وحينئذ للنقلي احتمالان إما أن يكون باطلا من حيث السند، أو يكون المعنى المتوهم أنه ظاهر منه، ليس كذلك، بل يكون المعنى المراد به معنى آخر بدلالة قرائن أخرى، غفل عنها الناظر لأول وهلة، وهذه الدلائل بها يظهر معنى آخر.
هذا هو القانون الكلي الذي أقام المجسمة وأتباعهم الدنيا وأقعدوها أو لم يقعدوها. وهذا الفعل منهم يبين كم هي نفوسهم ضحلة، ولا يعيشون إلا في ضباب.
وقد تكلم الإمام الرازي في كتبه على احتمال واحد من الاحتمالا العديدة فقال مثلا في كتاب أساس التقديس ص172:"الفصل الثاني والثلاثون في أن البراهين العقلية إذا صارت معارضة بالظواهر النقلية فكيف يكون الحال فيها."اهـ
والقانون الذي ذكره مبني على هذا الاحتمال، وهذا احتمال ممكن، وكونه ممكنا يدرك بمجرد فهم معنى الظاهر ومعنى البرهان كما أشرنا، فالظاهر لفظ محتمل مع رجحانه إذا أخذ منفردا في معنى، وأما البرهان فهو لا يستعمل إلا في القطعي من الأدلة، فصار كما لو كانت المسألة: لو تعارض قطعي وظني فكيف يكون الحال فيها، فالذي يقول إننا نقدم الظني على القطعي فهو مخطئ كما لا يخفى.
المسألة هكذا، بهذا البداهة، وبهذا الوضوح، إلا عند المتلاعبين من المجسمة. وقد قلتُ في تعليقاتي على كتاب درء التعارض لابن تيمية زعيم هؤلاء المجسمة ذوي الأصول الكرامية الدارمية، كلاما هو خلاصة هذه المسألة نذكره هنا لما فيه من فائدة:
والحاصل من كلام الرازي أن العقل القطعي والنقل القطعي لا يتعارضان قطعا، ولا يمكن تصور ثبوت التعارض، وكل دليل عقلي إما أن يكون دليلا برهانيا أي قطعيا أو غير قطعي أي ظنيا، وكذا الدليل النقلي إما أن يكون قطعيا ونقصد هنا القطعية في الدلالة والثبوت معا أو ظنيا في أحدهما أو كليهما، فالتعارض غير متصور بين العقلي والنقلي القطعي ومتصور في غير هذا، فإذا وقع تعارض فالمقدم هو القطعي مطلقا سواء كان النقلي أم العقلي، فوجه الترجيح والتقديم ليس هو كون الدليل عقليا أو نقليا بل كونه قطعيا أو لا، وإذا تعارض ظنيان كان المقدم هو الأقوى.
هذا هو خلاصة معنى كلام الرازي كما هو ظاهر، وقد خصص الكلام على حالة واحدة هي إذا كان التعارض واقعا بين قطعي عقلي وظني نقلي، فالصحيح إنه يجب تقديم القطعي العقلي أيضا، وعدم تسليم ما ينسب إلى النص النقلي أي عدم التسليم بأن المعنى الفلاني هو الظاهر، بل هو غير ظاهر لأنه قام الدليل على استحالة كونه مقصودا، أو يقال بالتفويض.
أما ابن تيمية، فليس كلامه هنا في نقض هذا الكلام مجردا أن إنه لا يقصد منه الوصول إلى نظرية في المعرفة شاملة وعامة، بل كل مراده هو الدفاع عن عقيدته التي يعتقدها، وهي التي أوضحناها فيما تقدم من كتابتنا هذه، وهي القول بالحيز والجهة والأعضاء وغير ذلك من التجسيم، فهو يحاول في كتابه هذا أن يصور أن الرازي ومن يشايعه وهم أهل السنة يردون النقلَ بالعقلِ، حتى لو كانت عقولهم ضعيفة والنصوص صريحة، وهذا تشنيع منه عليهم لا يستند إلى دليل كما سنرى أثناءتتبعنا لكلامه من كتابه هذا.
وكل من يقرأ بداية كتابه –أي درء التعارض- يقع في نفسه لجهالته أن هؤلاء العلماء فعلا يقدمون العقل على النقل، فيشرع بالتشنيع عليهم والتشيُّع لابن تيمية وغيره من أتباعه، وهو لا يعرف حقيقة الإشكال.
([2][5] ) راجع كتابنا "تدعيم المنطق والكلام ".